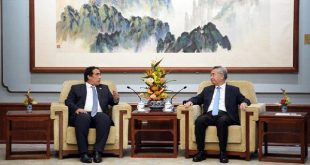خلود الفلاح
هل يمكن الفصل بين صاحب النص والمترجم؟ أعتقد كلاهما مسئول عن النص بصرف النظر عن لغته. السؤال الذي دائما ما يطرحه القراء. لماذا نكره نصوصا مترجمة ونحكم عليها بالفشل ويلحق المترجم بعضا من هذا الكره. هل يعني ذلك أن الترجمة تتطلب قدرات أو أدوات إبداعية ينبغي توافرها في المترجم، ضيفنا المترجم الليبي مأمون الزائدي يرفض ذلك ويؤكد أن الترجمة الجيدة تتحقق بقدرات المترجم اللغوية.
وأكد الزائدي أنه لا يستطيع ترجمة كتاب لا يحبه. وإذا ترك له الخيار فالنص الجميل يجدر أن لايبقى حبيس لغته ويجب مشاركة هذا الجمال مع القارئ.

سيرة الأحمر
قال المترجم مأمون الزائدي أن الترجمة تمنحه تمريناً لغوياً وابداعياً. وهي وسيلته الخاصة في تقاسم غنائمه النصية مع أصدقائه صعاليك الكتابة، وأضاف:”في التربية الرواقية إن صح التعبير التي تلقيناها جميعاً حيث الفضيلة هي إرادة الله وأعظم الراحات هي التي تعقب العمل الشاق. الترجمة تمنحي تلك الراحة. والترجمة تشبع نهمي للبحث. أثناء البحث عن كلمة ما أجد نفسي غارقاً في مواضيع ومباحث وعلوم بعيدة تماماً عن النص، وبسبب الإمكانات التي يوفرها الانترنت صار متاحاً التجوال والتسكع لوقت طويل حتى الظفر بالمطلوب إنها متعة مضاعفة”.
ورفض ضيفنا مسألة أن الترجمة هي إعادة كتابة النص وفق قدرات المترجم الإبداعية، فالترجمة حسب قوله، هي نقل النص إلى لغة أخرى وفق قدرات المترجم اللغوية وليس الإبداعية، ويضيف: “النص ليس ملك لكِ ولا تستطيعين التصرف فيه إلا في حدود نقل ما يقوله وليس ما تودين قوله. وهنا تواجه المترجم مشكلة النص في لغة أخرى حيث تختلف الثقافة والمفاهيم. فكيف يبقى النص كما هو أمام ثقافة أخرى؟ أعتقد أن هذه هي الترجمة المستحيلة. ربما يتطلب ذلك نصاً حقيقياً كتب للإنسان حيثما كان. النص الذي اسميه النص الكبير هو المطارد دائما وأمثلة ذلك من الأدب العالمي كثيرة وجلّية. ودون التطرق للأفكار النظرية من الواضح أنه لا يمكن كتابة النص نفسه مرتين وبالتالي المُقنع هو وصول رسالة النص إلى اللغة الأخرى. وليس هناك سقف لهذا الوصول رغم المسافة بينه وبين النص الأصلي. بل ينبغي أن تكون هناك أرضية يقف عليها النص المترجَم وحد أدنى يغرق لو انخفض عنه في الوحل ويُدفن في التراب. بالحديث عن المهارات الإبداعية إذا قام المترجم بتجويد النص عن طريق التدخل فيه فهذه ترجمة بتصرف وينبغي كتابة ذلك على عنوان الكتاب. اعتقد أن ذلك يحدث عند النقل من العربية إلى لغات أجنبية أو أنه مرغوب حينها. وهو عمل لا اقوم به أو اوافق عليه”.
طواعية العربية
أكد الزائدي أن ما امتعه أثناء ترجمة رواية “سيرة ذاتية للأحمر” لـ آن كارسون، أنها ليست حبيسة النوع الأدبي لتكون حبيسة عروض الشعر. وبالتالي فهي غير متقيدة بالشكل بمفهومه التقليدي. هي رواية شعرية ولكنها ليست كذلك إلا روحاً او ضمناً، فتعبير رواية شعرية كنوع يتضمن نصاً حول موضوع ما يُكتب في مقاطع تلتزم بقافية أو إيقاع معين ربما تشبه الأرجوزة عندنا بدرجة ما كما اعتقد. ولكن كارسون ابتعدت تماماً عن ذلك كتبت نصاً شعرياً نثرياً يذهب إلى الأسطورة ويعيد إنتاجها في شكل حكاية كتبت في مقاطع بشاعرية عالية.
وتابع: كارسون قدمت للنص منذ البداية بل وأعادت كتابة القصة كما كتبها الشاعر سيستيكورس ولكن بكلماتها هي ووجهة نظرها هي. الرواية ذات قيمة عالية جداً وقد حظيت باهتمام عدد كبير من النقاد. وهي لا تتكشف تماماً من القراءة الأولى. نفاذ الصبر كما يقول كافكا في حكم تسوراو هو النقيصة البشرية الأساسية وأنا لا أفكر في ترك العمل بعد أن أشرع فيه، ربما اتركه جانباً وأعود لاستكماله لاحقا.
وأشار صاحب ترجمة ” الفارس” أن هناك خسارة في الترجمة وهناك فقد. ومن الصعب ترجمة الشعر تحديدا فهو يستغرق وقتا أطول ويحتاج إلى تمعن أكثر بسبب قوامه اللغوي الخاص. في السرد القصصي تتكفل الكلمات المتتابعة بإنتاج الدلالة ضمن هرم أكبر، أما في الشعر فالتكثيف والاقتصاد يٌكسب الأمر صعوبته. الشعر لعبة ذكية جدا. ومن حسن الحظ أن اللغة العربية فسيحة وطيعة ويمكنها أن تستوعب نوايا المترجم الحسنة. الترجمة الأدبية على وجه الخصوص تُفضّل أن يكون المترجم مُبدعاً حيث يكون أكثر قدرة على اكتناه النص وتحري بواطنه وفهم اشاراته ثم استيعابه.
وأكد صاحب ترجمة “بستنة في المنطقة الأستوائية“أنه من الضروري للمترجم أن يكون ملماً بقواعد اللغة العربية ومحسناتها البديعية. وإلا فكيف يمكنه الكتابة بالعربية. من البديهي طبعاً أن يتقن الكاتب اللغة التي يكتب بها بدرجة كافية فلا أحد يتقن أي لغة تماماً كما يجب حتى لو كانت لغته الأم.
وتابع: من الضروري أيضاً وجود المدقق اللغوي والمحرر وهما وظيفتان توجدان على استحياء في أوساطنا وهما ضروريتان من أجل نص سليم وكامل. والمدقق اللغوي ضروري لحياة اللغة واستمرارها وهو أمر يهمنا جميعاً. بينما يتولى المحرر إعادة الصياغة تجويداً للنص مقترحا رأيه على الكاتب أو المترجم. يبقينا ذلك بعيداً عن الاصطدام بنصوص تعتريها شوائب كان يمكن تلافيها ومداراتها. علينا الفراغ من موضوع البنى التحتية للنص لأن ذلك لايجب أن يستغرق أكثر من اللازم. ايقاع الحياة سريع وهي دائماً في مكان آخر وعلينا مطاردتها.
ترجمة رديئة
قال المترجم مأمون الزائدي هناك ترجمة جيدة وأخرى سيئة. تماماً مثلما هو كذلك في أي لغة اصلاً. عند الترجمة ينتقل النص بكامله إلى اللغة الأخرى. وعملية الانتقال هذه يجب أن تكون كاملة أو تقترب من الكمال قدر الإمكان وإلا فإن النص لن ينفع ولن يبعث في القارئ على الأقل تلك النشوة الغامضة التي يبحث عنها في القراءة. وعملية الانتقال هذه يحرسها جيش جرار من المنظرين والفلاسفة في مسعى خرافي لتحقيق الكمال المنشود.
وتابع: في تجربتي مع رواية الكاتبة المكسيكية الشابة فاليريا لوزيللي “قصة أسناني”، حدث شي جدير بالذكر في هذا السياق، فقد تعاونت الكاتبة مع مترجمتها السيدة ماكسويني على إعادة الكتابة من جديد باللغة الإنجليزية رغم صدور العمل بالاسبانية قبل ذلك. وكتبت فى آخر الكتاب أنها بهذا لاتعتبر الكتاب مجرد ترجمة بل هو اصدار جديد أي كتاب جديد. وقد ابلغتُ مؤخراً عن طريق وكيلها الأدبي أن النسخة المعتمدة للترجمة هي الإنجليزية وليست الإسبانية في معرض سؤاله عن أي اللغتين قمت بالترجمة منها. يعني ذلك أن الترجمة حقاً عملية كتابة ثانية. ومن هنا تأتي الأهمية الحتمية للإجادة. من الطريف ذكره في هذا الشأن أن هيئة مرموقة للنشر في دولة شقيقة رفضت نشر الرواية لأنها كتبت اصلاً بالإسبانية وأنا ترجمتها عن الإنجليزية من النسخة التي ذكرت فيها المترجمة أنها تخلت عن النص الإسباني واعتمدت الآخر ومع تأكيد الوكيل الأدبي لذلك.
ثم أن الترجمة مساهمة ومشاركة في هذه الملحمة العظيمة للوجود الإنساني وعليها أن تكون فعالة ونشطة وجادة. فهذه الحياة لنا جميعا ونحن معاً في كل شيء.
وأضاف: “لا يفكر أحد بوضع لائحة بمواصفات المترجم (الجيد( فذلك غير ممكن. إنها مسألة ذائقة ونحن نتعامل مع عمل فني يتذوقه كل شخص بطريقته. إلا أنه لا مناص من أن يكون على وعي ودارية بالخامة التي يشتغل عليها وهي هنا اللغة من طرفيها وأن يهتم بالتفاصيل. أنا في هذا السياق أمتن لتوجيهات الأستاذ الجليل القاص والصديق على الجعكي ولنصائح المترجم الكبير الأستاذ فرج الترهوني التي افادتني حقاً حيث أنها انتزعتني من النص المقابل كي تضعني في مواجهة النص الذي أكتبه في صورة ترجمة.
وراء النص
أوضح صاحب ترجمة ” بضع جمل قصيرة عن الكتابة” أن هناك علاقة حميمة تتولد بينه وبين النص أثناء ترجمته، القاريء الجيد يدرك ما أعنيه بقولي إن القراءة مثل السفر تماماً أنتِ تقابلين أشخاصا وتقصدين أمكنة تترك أثرها في نفسك تثير ذكرياتك و تُبهجك بمتع ومسرات لاتنتهي. وفيما أنتِ تتابعين الشخصيات في القصة وتنفصلين تدريجياً عن هذا العالم إلى عالم الكتاب منقادة كلياً دون فكاك من اسر الكلمات المكتوبة بعناية وقصد.المترجم يفعل بكِ ذلك وهو يكتب، إنه قارئ وكاتب في آن واحد. وربما حين نفكر في الأمر نجد أن انغماسه ربما يتجاوز انغماس الكاتب في الكتابة. لأنه أمام عمل مفروغ منه لا يشتت متعته إنتاج النص واستيلاد معانيه. أنت تقرأين النص وتحبينه ثم تقررين صنعه بنفسك من جديد. أي أن تكتبيه كما فهمته.
وتابع: في ترجمتي لرواية الكاتب التشيلي الكبير انطونيو سكارميتا “أب بعيد”، تأثرت بقصة الولد الذي تركه والده لأسبابي الخاصة وعندما ترجمت ونشرت الفصول الخمسة الأولى بالموقع الالكتروني الليبي “بلد الطيوب”، وصلت الرسالة على الفور إلى الأستاذ الشاعر الكبير مفتاح العماري وأدرك مباشرة ماذا وراء النص فكتب معلقاً بما هو معهود عنه من ذائقة رفيعة لا تُطال وحنو ومحبة أن الترجمة محمّلة بدلالات أنتجتها ذات المترجم، رغم تقيدي الحرفي بالنص الأصلي. وشكلت تلك الكلمات وحدها دافعاً وحافزاً لي لن ينضب ابداً. في ديوان “بستنة في المنطقة الاستوائية” للشاعرة الجامايكية أوليف سنيور التي تتميز بروح مرحة وتدس التهكم في نصوصها كان من الضروري إنتاج نص قوي وصلب يعكس روح المقاومة والتشبث بالأرض وفي نفس الوقت نص ملون وجميل ينقل طعم المناطق الاستوائية الخام والبكر ودس تلك التهكمات في مكانها تماماً دون إبرازها وإلا فإنها ستطيح بوقار النص في بعض الأماكن. كذلك الحال مع غوستافو سانشيز. بطل رواية “قصة أسناني”، حافظت على أن يبقى كيخوتياً قدر المستطاع وهو شخص قليل الحيلة يكذب على نفسه ويصدق ذلك دون تردد. وتابعت قصته مع حس سائد بالطرافة واثارة الضحك. لا يمكن أن تنجح في ذلك إذا لم تربطك علاقة حميمة ووثيقة بالنص.
 منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية