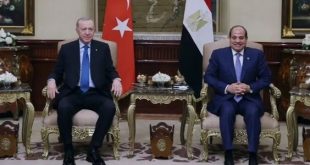زايد ..ناقص
جمعة بوكليب
فيروس كورونا، أحالَ حياتنا، مؤخراً، إلى جحيم. حين انفلت من مصدره، وبدأ يجوبُ بلدان ومدن العالم طليقاً، ضارباً عرض الحائط بكل ما شيّدته البشرية والطبيعة من حدود وحواجز، لم يُحْضرْ في جرابه الموتَ، والخوفَ، فقط، بل أحضرَ، أيضاً، مفردات جديدة، أضافها بكرم وسخاء إلى قاموس الحياة اليومية، وصارت تتردد على ألسنة الناس، وفي وسائل الاعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي بإعتيادية. ففي بريطانيا، مثلاً، فاجأتنا وسائل الاعلام، في الأيام الأولى، لظهوره بمصطلح غير معهود، أطلقوا عليه مناعة القطيع. وأعتُبرَ شرط ٌضروري للمواطنين في كل أنحاء البلاد، للاصابة بالفيروس، بهدف اكتساب المناعة الطبية مستقبلاً في حالة عودة الفيروس، وعدم تمكن المختبرات الطبية من التوصل إلى مصل واق. هذه الاستراتيجية الرسمية استمرت قرابة أسبوعين، لكن حين تبيّن عدم جدواها بارتفاع أعداد المصابين، وتفاقم أعداد الموتى، رأتْ الحكومة التخلّصَ منها، والعودة إلى المربع الأول بتنّي استراتيجية أخرى، قديمة، لا تختلف عن وصفة طبية أثبتت جدواها، ونفذت بحذافيرها في دول أخرى مثل الصين وغيرها، تؤكد على ضرورة التخلص من الفيروس بفرض سياسة تقوم على عزله، من خلال اجبار المواطنين على البقاء في بيوتهم، مما يعني كذلك فرض تعطيل مؤقت لكل قطاعات ومرافق الحياة.
تبنّي هذه السياسة، أدّى سريعاً إلى اختفاء مصطلح مناعة القطيع، مثل فص ملح وذاب. وظهرت مفردة أخرى، أو مصطلح آخر، أطلقوا عليه التباعد الاجتماعي، بمعنى الحرص على تفادي الاقتراب والاختلاط اجتماعياً، حماية للنفس، وتجنباً لانتشار الفيروس، وحرصا على تجنيب الآخرين الاصابة.
الذين جاءت بهم الأقدار، أو دفعت بهم الظروف، ووجدوا أنفسهم يخوضون في مسارب الواقع اللندني اليومي، وليتعاملوا مع منزلقاته، وسرعات ايقاعاته، وتعقيداته المتعددة، عرفوا من خلال تجاربهم الشخصية، ومعاناتهم اليومية، أن التعليمات ربما تكون ضرورية وصعبة التنفيذ على سكان مدن في بلدان أخرى، ولكن ليس في مدينة لندن.
سكان لندن، لمن عاش بينهم، ليسوا في حاجة إلى تعليمات طبّية أو حكومية رسمية تطلب منهم ما أطلقوا عليه مصطلح التباعد الاجتماعي، لأن المصطلح وإن لم يكن متداولاً اعلامياً، إلا أنّه قديم، وبجذور عميقة في تربة واقع الحياة في المدينة، وسمة رئيسة من سمات تميّز العيش فيها، والانخراط في طاحونة روتينها.
النظرة المحايدة لخريطة لندن، ومعالمها، ومناطقها، وتشعبات مسارات طرقها، وقضبان حديد سكك قطاراتها، فوق أو تحت الأرض، ربما يكون عامل اثارة في نفس من لا يُخْبرها، ولم يجرّب محنة العيش بها. فالخريطة محايدة. وهي على سبيل المثال، لا توضح الجدران غير المرئية التي شيّدت، عبر السنين، اجتماعياً بين البشر. ذلك، أن تعقيدات ومصاعب ومتطلبات الحياة الواقعية وما نشأ عنها اجتماعياً من أنماط عيش، وما ترتب عليها تباعاً من قواعد وأنماط سلوك، جعلت التباعد الاجتماعي سمة يومية تُعاش، وليس مادة للاحاديث. فالمرء منذ أن يغادر بيته صباحاً يدخل في قالب يومي يحتّم عليك السير، في طرقات وشوارع، معزولاً بجدران غير مرئية عن غيره من البشر. وقد يقضي نهاره كله، خارج البيت، ويعود إليه مساءً متعباً، من دون تذكر حادثة واحدة فتح فيها فاه بكلمة! قد يرى البعضُ أن هذة مبالغة منّي، لكن الحقيقة أكثر سؤاً من ذلك لمن جرّبوها، وقاسوا معاناتها. وبالتأكيد، فإن ما ينطبق على الحياة اللندنية قد يطال مدن أخرى وباختلافات، لكن الحقيقة هي أن الحياة في مدن كبرى مكلفة نفسياً ومالياً واجتماعياً، لأن الانسان فيها يتحوّل، بمرور الوقت، إلى جزيرة معزولة، محاطة بجزر معزولة.
 منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية