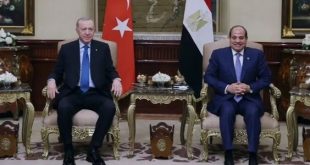زكريا العنقودي
في ذلك الصباح في مطلع الثمانينات ، كان الشتاء حقيقيا ، واغتسلت الارض بالمطر حتى فاحت منه رائحة التراب .
بمحطة ميدان الغزالة ، كنت أنتظر حافلة عرادة السوق ، بيش توصلني لمعهد ( مالك بن انس الديني ) بالهاني حيث كنت ادرس ، وذلك بعد أن وصلت إليها راجلا من شارع الجمهورية ، متحاشيا زخات المطر بالطريق من خلال المرور من تحت (مطاردات) عمارات وسط المدينة .
بالمحطة كنت محاطا بكذا رئيس عرفة ، كانو بدورهم متجهين وعلى نفس الحافلة لقاعدة عقبة بن نافع ، هكذا كانت تسمى حينها والتي كانت تقع بأخر الخط .
بعد تأخر معتاد ، وصلت الحافلة ركبنا جميعا ، وكان السعر لتوه قد زاد فصار بعشرة قروش ، ثم أنه لم يعد ثمة محصل تذاكر (بوليطاي ) . وكان البديل ماكينة لجوار السائق دائمة الاعطال هي من تمنحك تذكرة الصعود .
كعادتي كنت أتجه من فوري للخلف مرورا بكل اولئك الركاب المبللين بالمطر من فرط الانتظار بالمحطة ، كنت أذهب لهناك حيث اجد متسعاً استطيع فيه انا التلميذ النحيل قصير القامة ، ان استند بكلتا يداي ، على أحد القضبان المعدنية متحاشيا الوقوع من فرط تهالك الحافلة ، واندفاع سائقها السريع عبر الظهرة فشلوم العامرة بالحفر والمطبات .
كنت هناك بالمؤخرة الطالب الوحيد وسط مجموع العساكر .
لاشئ يجمع بيننا ، لا العمر ولا الهدف ولا المهنة ، بل أنهم كانو كلهم بشوارب عريضة( شنابوات ) وكنت بالكاد نمت على شاربي شعرتان ، لم يكن هناك وجه شبه واحد يجمعنا سوى أننا كلنا على نفس الحافلة وكنا جميعاً نرتدي البدلة العسكرية الخضراء بدلة الشغل .
كنت أتامل جمعنا هذا حينها الذي لا يتشابه في شئ .
واردد في نفسي ، اللعنة ما الذي جمعني بهؤلاء، فما انا إلا طالب مدني بسنة اولى ثانوي وبالكاد أستطيع ان اتجاوز الحصة الاولى و تسميع الشيخ الزقوزي
(قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) .
 منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية