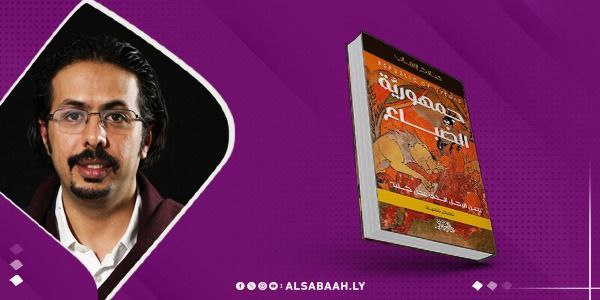خلود الفلاح
قاص وروائي ليبي، يؤمن أن الكتابة تنطلق من تراكم داخلي، ومن تأمل طويل في فكرة ما،
في روايته الصادرة حديثا “ما بعد الهرمجدون” والتي تتقاطع بين الدستوبيا والميتايفزيقا، بين سرد فلسفي وتأمل شعري. تطرح سؤال الإنسان وهويته في عالم يعيش تحولات عدة على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.
وفي كتابه “ما قبل وما بعد: تحريك حروف العلة” يقدم وجهة نظره في مسائل الهوية، والمواطنة، والدين والدولة، والتعددية، مفاهيم التعايش السلمي المشترك في ليبيا.
يؤمن أن هويته الامازيغية لا تقف حاجزا، بينه وبين الليبيين من مختلف المكونات، بل هي مشروع لغوي وفني وفلسفي، يرفض أن تكون الهوية سجنًا.
الكتابة لديه ليست عملًا رومانسيًا، بل عملية شاقة تتطلب وعيًا وتأمل في الوجود.
البداية
ـ إلى أي مدى أثّرت الثقافة والفنون الأمازيغية في تكوينك ككاتب؟
ـ الثقافة الأمازيغية كانت حاضرة في وعيي منذ الطفولة، لا كموروث تقليدي فقط، بل كأفق لغوي وشعوري وموسيقي شكل هويتي الأولى. ترعرعت بين الأغاني الشعبية وطقوس “تسيساو تميلاو” وأغاني أيدير واشعار سعيد سيفاو المحروق، حيث تتداخل الحكمة مع الشعر والرقص، ويصبح الفن وسيلة للتعبير عن الوجود. لم أتعامل مع الأمازيغية كقضية سياسية فقط، بل كلغة قادرة على حمل المعاني العميقة، وعلى طرح الأسئلة الكبرى التي عارض وجودها النظام الرسمي وأيضا وعي التعاطف الشعبي الغائب لما يقارب النصف قرن. ولذلك، عملت في كتاباتي الأولى على تحرير هذه اللغة من ثنائية المظلومية أو الفلكلور، لأعيد صياغتها كأداة تفكير وخلق جمالي.

أعتبر علاقتي بها شبيهة بما وصفه الشاعر الألماني بول تسيلان حين قال “اللغة تمشي نحو الفناء، لكنها لا تزال تحمل داخلها شهادة ميلادها”.
اللغة الأمازيغية عندي ليست فقط ما نُطق، بل ما صُمِتَ عنه، ما حُجِب تاريخيًا بفعل القمع الثقافي والسياسي. من هنا كانت محاولتي ربط هذا التراث الصامت بالحاضر، لا استهلاكًا له بل لإعادة تشكيله ضمن مشروع لغوي وأدبي حديث وحيّ يعيد رسم الهوية الليبية وعلاقة الليبيّين بالاض والتاريخ بعيدا عن مشاريع الشعبويين وخطابات الأيديولوجيات التي تعلن ميلاد الهويات القاتلة.
ـ هل تعتقد أن المتغيرات التي تشهدها مجتمعاتنا كسرت القوالب النمطية للفنون، ومن بينها الرواية؟
ـ نعم، أعتقد أن التحولات التي تمرّ بها مجتمعاتنا – سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا – دفعت الأدب، وخاصة الرواية، إلى إعادة تشكيل نفسها. لم يعد ممكنًا للرواية أن تبقى في دور المؤرخ أو حامل الرسالة القومية، أو أن تكتفي بسرديات متماسكة تُطمئن القارئ. ما نعيشه من فوضى وتشظٍ انعكس بشكل مباشر على شكل الرواية ومضمونها. النص الروائي أصبح اليوم أكثر هشاشةً، وأكثر قدرة على التقاط التفاصيل الصغيرة والهواجس الفردية التي طالما وُصفت بالهامشية.
في السياق الليبي، مثّل سقوط نظام القذافي لحظة قطيعة مع مركز السلطة التي لطالما ادّعت احتكارها للمعنى وتوجيهها لخطاب النخبة. كانت المؤسسة الرسمية تملك رواية واحدة، مصمتة، عن الواقع والتاريخ والمستقبل. لكن ما بعد 2011 كشف هشاشة تلك السردية، وفتح المجال لتعدد الأصوات، بما فيها أصوات كانت مهمّشة بالكامل. لم يعد ثمة مركز يفرض المعنى، بل تحوّلت الرواية – بالمعنى الأدبي والمعنوي – إلى ساحة تجريب، ووسيلة لفهم الذات والآخر في واقع لا مركز فيه، ولا سلطة تنسّق الكلام أو تصدر الفتاوى الثقافية.
رواية مثل “خبز على طاولة الخال ميلاد” للكاتب الليبي محمد النعّاس تُجسّد هذا التحوّل. هي ليست فقط كسرًا للنمط السردي أو للثيمات المعتادة في الأدب الليبي، بل أيضًا تفكيك ذكي لتصورات راسخة عن الجندر والسلطة والمعنى الاجتماعي للرجولة في مجتمع ريفي. هذا النوع من الكتابة لا يدّعي تمثيل الكل، بل يجرؤ على طرح الأسئلة من زوايا كانت تُقصى أو تُعتبر “غير أدبية”.
الأدب الذي يُكتب من الهامش – سواء كان هامشًا اجتماعيًا أو لغويًا أو نفسيًا – لم يعد مجرد أدب معاناة أو احتجاج، بل أصبح ضرورة لتوسيع أفق الرؤية. كما قال غابرييل غارسيا ماركيز “الواقع أكثر جنونًا من الخيال، والمشكلة أن الرواية تحاول فقط أن تُمسكه”. كذلك نجد في الأدب أصبح كثير الميل لتفجير الشكل من الداخل، والاعتماد على اليومي والعادي كأدوات تفكيك للعالم.

حتى الفلاسفة، كهايدغر، أدركوا أن الحداثة لا تطلب أجوبة بقدر ما تطلب أسئلة جذرية. قال:
“ليس المهم أن نملك أجوبة، بل أن نملك الشجاعة لطرح الأسئلة الصحيحة” والرواية، بصيغتها الجديدة، لم تعد تقدم حكاية، بل تختبر معنى أن نحكي من جديد.
نحن أمام نصوص لا تواسي القارئ ولا تؤكد له العالم كما يعرفه، بل تخلخل تصوراته، وتدعوه إلى إعادة التفكير في كل شيء، حتى في اللغة التي يُكتب بها النص.
ـ في مجموعتك “جمهورية الضباع”، هناك إسقاط على ليبيا. بين الرواية والواقع، أين تقف الكتابة؟ وهل الأدب قادر على إحداث تغيير؟
ـ “جمهورية الضباع” لم تكن محاولة لنقل الواقع الليبي بلغة رمزية فقط، بل كانت نقدًا عميقًا لبنية السلطة والعنف والخراب المتوارث، بلغة سردية تتجنب المباشرة وتُركّز على تفكيك آليات الهيمنة التي لا تُرى بالعين المجردة. لم أكتب نصوصًا سياسية بالمعنى الدعائي، بل نصوصًا تُمارس السياسة من خلال الأدب: من خلال بناء شخصيات تعكس تعقيدات الواقع، وصراعاته القيمية، وانهياراته الرمزية.
أنا لا أؤمن أن الأدب يغير الواقع مباشرة، لكنه يغير علاقتنا به. كما قال كافكا:”الكتاب يجب أن يكون الفأس التي تكسر البحر المتجمد في دواخلنا”. والأدب الحقيقي هو الذي يزعزع استقرار الأفكار الكسولة، ويفضح ما يُعتبر بديهيًا. الأدب لا يقلب الأنظمة، لكنه يوقظ وعيًا، وهذا هو التغيير العميق الذي لا يُقاس بالزمن السياسي، بل بالتراكم الثقافي.
ـ هناك من يرى أنك متعصب لكل ما هو أمازيغي. ما هو ردك؟
ـ من يرى ذلك، ينظر إلى التزامي من زاوية ضيقة. أنا لا أكتب لأرفع راية، بل لأكشف ذاكرة تم تهميشها عمدًا. أنا ابن لغة تعرضت للطمس، وابن شعب عانى الإقصاء من مؤسسات التعليم والثقافة والدين. من الطبيعي أن يكون للأمازيغية مكان محوري في مشروعي الأدبي، لكن هذا لا يجعلني متعصبًا، بل منخرطًا في معركة استعادة التعددية والعدالة الثقافية.
أكتب بالعربية والأمازيغية، اكتب بالألمانية أيضا، وأقرأ العالم من خلال عدسات متقاطعة. لم أقف ضد الآخر، بل ضد التماثل القاتل، ضد فرض سردية واحدة. كما قال نيرودا: “الذي لا يطالب بحقه، لا يُحسب خَصمًا، بل تابعًا”. ولذلك أرفض أن أكون تابعًا لثقافة أحادية ترى التنوع تهديدًا لا ثراءً.
هويتي الأمازيغية ليست حاجزًا، بل جسرًا أنطلق منه لفهم الإنسان. من لا يفهم هذا، ربما لم يقرأني بإنصاف.
هذا التصنيف شائع، تصنيف من يدافع عن الأمازيغية أنه عنصري شبيه بالقول أن من كان يقف ضد نظام الأبارتايد في حنوب افريقيا يكره البيض، هو رده فعل ربما مريحة بالنسبة للبعض: أن تصف شخصًا ما بـ”المتعصب” فقط لأنه يكتب بلغته الأم، أو يحاول استعادة ذاكرة ثقافية تم إقصاؤها طويلًا.
بالنسبة لي، الأمازيغية ليست راية أرفعها في وجه أحد، وليست رد فعل على ظلم، رغم أن الظلم واقع. هي ببساطة اللغة التي كنت سأحلم بها لو كنت حرًا منذ البداية، وهي الوسيلة التي أختبر بها علاقتي بالعالم، باللغة، وبالوجود نفسه.
أكتب بالأمازيغية لأنني أؤمن أن اللغة ليست أداة تواصل فقط، بل طريقة للوجود. كما قال بول تسيلان، الشاعر الألماني الناجي من المحرقة “اللغة هي المكان الذي يمكن أن يُنقذ فيه الإنسان”. وأنا أبحث عن ذلك المكان، لا أكثر.
أفهم أن من نشأ داخل خطاب الدولة المركزية، أو تعلّم أن الوطنية تُختصر في لغة واحدة، قد يرى في كل كتابة بالأمازيغية نوعًا من التحدي أو الانفصال. لكن في الحقيقة، ما أفعله هو العكس تمامًا: أنا أحاول إعادة إدخال المهمّش والمنسي إلى قلب الثقافة، لا إخراجه منها.
الهوية التي أشتغل عليها ليست هوية مغلقة أو فلكلورية. هي مشروع لغوي وفني وفلسفي، يرفض تحويل اللغة إلى وثن أو علم، ويرفض أن تكون الهوية سجنًا. ولذلك أكتب بالأمازيغية والعربية والألمانية، وأغني للحب والموت والطفولة، لا للشعارات. إذا كان هذا “تعصبًا”، فهو تعصب للإنساني في الإنسان، لا لما هو قبلي أو قومي.

ـ تحضر الفلسفة في أعمالك دائمًا.. كيف تبرر ذلك؟
ـ الفلسفة لم تدخل كتابتي كزينة فكرية، بل كحاجة عضوية نابعة من طبيعة الأسئلة التي أطرحها. منذ سنواتي الأولى في الكتابة، شعرت أن السرد وحده لا يكفي لفهم العالم من حولي، وأنه لا بد من مساءلة المفاهيم لا فقط الحكايات. لذلك لجأت إلى الفلسفة، لا كمنهج أكاديمي، بل كأداة لكسر الجمود.
النص عندي ليس مجرّد سرد، بل فضاء تفكير. أدمج اللغة بالحيرة، والبنية بالمفارقة، والشخصيات بالسؤال. هذا لا يعني أنني أكتب نصوصًا نُخبوية أو معقدة، بل أنني لا أقبل بالسرد المطمئن. أكتب كما أفكر، وأفكر كما أشكّك. وهذا ما يجعل الفلسفة حاضرة في كل صفحة أكتبها، لا بوصفها علمًا، بل ممارسة وجودية.
ـ في الغربة، من أين يولد أبطال رواياتك؟
ـ يولدون من التفاصيل اليومية التي يمر بها الهارب من عنف السردية المجتمعية والمنفي والمهاجر الى هوية المواطن العالمي. من لحظة الانتظار الطويل في مكاتب الهجرة، من نظرة الشك، من الأوراق الرسمية، من نظرات الأبناء وهم يحاولون فهم لغة غريبة عليهم، ومحاولتي فهم لغة أطفالي التي امتلكوها كما امتلكت لغتي الأم، غريبةً عن الآخرين جميعا، لكني في هذه اللحظة أنا الغريب الذي عليه أن يقبل اختلاف أطفاله، وميلادهم الجديد.
الغربة ليست فقط انتقالًا جغرافيًا، بل ارتباكًا مستمرًا في تحديد من تكون، وكيف تروي نفسك في مجتمع لا يعرفك.
أبطالي لا يأتون من الخيال الخالص، بل من مشاهد عشتها أو سمعتها أو شعرت بها. فالشخصيات الحقيقية لا تُخلق، بل تُكتشف. وأنا أكتشف أبطالي في وجوه المهاجرين، في صمت المنفيين، في دهشة الطفل الذي يُطلب منه إثبات هويته في بلد ولد فيه لكنه لا يُعترف به بسبب لون البشرة أو اتجاه قبلة العبادة التي يجعلها جيرانه.
الغربة عندي ليست موضوعًا، بل بيئة للكتابة. بيئة تُنتج شخصيات ممزقة، لكنها قادرة على طرح أسئلة لا تطرحها الشخصيات المستقرة.
ـ هل لديك طقوس خاصّة تحضّر بها نفسك للكتابة؟
ـ ليست لدي طقوس بالمعنى الكلاسيكي، لكن أحتاج إلى شروط معينة كي أكتب: نوع من السكون الداخلي، مساحة ذهنية تسمح بالتأمل والتقاط الخيط الأول للفكرة. الكتابة لا تأتي عندي من “إلهام” مفاجئ، بل من تراكم داخلي، من تأمل طويل في فكرة ما، حتى تنفجر على الورق.
في بعض الأحيان أكتب على دفاتر، أحيانًا على الهاتف، وغالبًا في أوقات متأخرة من الليل. ما أؤمن به هو أن الكتابة فعل يومي، حتى لو لم يكن إنتاجيًا دائمًا. فالكاتب هو إنسان يجد صعوبة في الكتابة أكثر من أي إنسان آخر، وأنا أجد في هذه الجملة صدًى لتجربتي.
الكتابة عندي ليست عملًا رومانسيًا، بل عملية شاقة تتطلب وعيًا وإرادة، وحتى مقاومة للكسل والتشويش. هي التزام فكري وجمالي، لا هواية.
 منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية