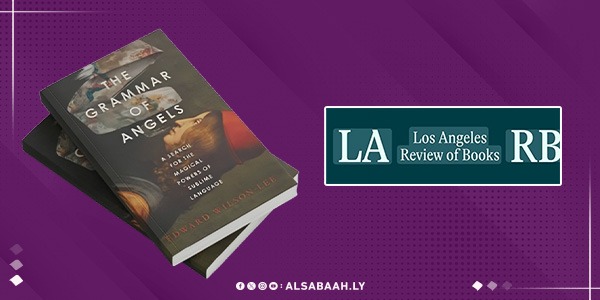ترجمة عبدالسلام الغرياني
رغم عواصف التاريخ الجارفة، تحافظ اللغة على مكانتها كأهم أدوات التواصل البشري.
إنها الوسيلة التي نصل بها إلى القلوب والعقول، والخيط الذي يربط شتات الأفراد محولاً إياهم إلى كيان جمعي تتفجر منه طاقات هائلة لا يمكن تحقيقها بشكل منفرد.
هذه القوة الناقلة للكلام هي المحور الذي يبني عليه إدوارد ويلسون لي كتابه الجديد “قواعد الملائكة: البحث عن القوى السحرية للغة السامية”.
يظهر العمل كإنجاز غريب يصعب إدراجه تحت تصنيف واحد، حيث يمزج بين فلسفة اللغة.
والنقد الأدبي، متخذا من سيرة العالم الموسوعي في عصر النهضة جيوفاني بيكو ديلا ميراندولا (1463-1494) إطارا لحكايته، وهو الذي أثارت أفكاره الجدل في الكنيسة وتحدت المسلمات الفكرية لعصره.
في عام 1486، وصل الشاب بيكو إلى روما للدفاع عما أطلق عليه “فلسفته الكونية”، التي صاغها في 900 أطروحة وخلاصة، مدعياً أنها تقدم تصوراً شاملاً “لكل المعارف الممكنة”، وتوحّد بذلك فلسفات العالم المتنوعة من تراث الفلاسفة المسلمين إلى الفكر الأرسطي والأفلاطوني.
على الرغم من التناقضات الجوهرية بين العديد من هذه المدارس الفكرية، آمن بيكو بنظامٍ تكون فيه كل فلسفة “صحيحةً في إطار منطقها الخاص”، معتبراً أن “تراكم الحقائق المتباينة” يمكن أن يقودنا إلى فهم أعمق لمكانتنا في هذا الكون.
كان بيكو – الطفل المعجزة – موضع إعجاب الجميع لإنجازاته الفكرية الاستثنائية، لكن حتى بالنسبة له، بدا هذا المشروع طموحاً بشكل غير مسبوق. لعلّ مصدر ثقته يستمدّ جذوره من انجذابه العميق نحو ما أطلق عليه ويلسون لي “الوحدة الجوهرية الكامنة وراء الوجود”، حيث أدرك بيكو أن جميع الفلسفات – على تنوعها – تتوق في صميمها إلى تحقيق هذا المثال الأعلى. مما يثير تساؤلات مصيرية: كيف يمكن للغة – بحدودها – أن تحتضن “فلسفة كونية” بهذا الاتساع؟ وهل تمتلك الكلمات القدرة على نقلنا إلى أعتاب إدراك تلك “الوحدة الكامنة”؟
توقّعاً من ويلسون-لي أن قد يرمي القارئ بالإمكانات السامية للكلمات بتهمة “الخزعبلات والترهات”، فإنه يستحثنا على التفكر في التساؤلات التالية:
لماذا تستطيع القصيدة الجميلة أو المقطوعة الموسيقية أن تقشعر لها أبداننا؟
كيف يمكننا فهم ظاهرة استماعنا لخطاب مؤثر أو أغنية ما فنجد أنفسنا منجرفين مع تيارها، بل حتى وكأننا نحن من ينطق أو يغني تلك الكلمات ذاتها؟
فاللغة – خاصة عندما تنتقل عبر الغناء – تستطيع أن تنقلنا إلى ما وراء ذواتنا. وعندما يحدث هذا، تبدأ فرديتنا في التلاشي.
يمكن للكلمات أن تجمعنا في تجارب جماعية تلمح ربما إلى شيء من الوحدة الكامنة التي سعى بيكو إليها.
وبالطبع، لم يكن بيكو الفيلسوف الوحيد الذي انجذب إلى ما وراء عالم الذات الفردية. يضع ويلسون-لي ضمن تقليد فكري يمتد إلى الفيلسوف اليوناني بارمنيدس، الذي رأى أن “كل الفروق بين الأشياء” مجرد “أوهام”، وخلص إلى أن “الكل واحد”.
وقد شغلت العلاقة بين التجربة المادية الفردية – عالم هذه “الفروق” الوهمية – وبين ما يصفه ويلسون-لي بأنه “عالم ميتافيزيقي آخر”، أجيالاً من الفلاسفة من أفلاطون إلى كانط. ويمكننا افتراض أن اللغة تقع بشكل راسخ في عالم تلك الفروق التي – وفقًا لبارمنيدس – ليست سوى أوهام. ففي النهاية، عندما نستخدم كلمة ما، فإننا نؤكد إدراكنا لتلك الفروق الدقيقة التي تمكننا من التعامل مع العالم.
هل يمكننا تصوّر نمط من أنماط التواصل لا يخضع لتلك الشروط؟ في إيطاليا القرن الخامس عشر، كان هناك اعتقاد سائد بوجود نوع آخر من اللغة لا يقتصر على العالم البشري – ألا وهي لغة الملائكة. تمثل الملائكة حاضرة ثابتة في كل دين من الأديان الكبرى: فهم يُفهمون كرسل الله في التقاليد المسيحية واليهودية والإسلامية. موقعهم يتوسط بين البشر والله، وأصواتهم تعمل كوسيط بين الإنساني والإلهي.
يشرح ويلسون-لي أن الكثيرين اعتقدوا أن كلام الملائكة كان “قوياً لدرجة أنه لا يحاول التعبير عن الأفكار مثل الكلام البشري، بل يجعل أفكار ملاكٍ ما تسكن ملاكاً آخر، مما يذوب الحدود بين الاثنين بطريقة تترك الأمر غير واضح ما إذا كان لا يزال هناك كائنان أم واحد فقط.” احتاج بيكو لفلسفته الكونية شكلاً من الكلام يستطيع إذابة الحدود.
هدفه، كما صاغه عام 1486، يقف في معارضة مذهلة لنموذج بارمنيدس: لقد أراد أن “يحول الجميع إلى واحد.” ربما حملت لغة الملائكة الجواب.
لكن هل يمكن للغة البشر أن تلامس عالم “الخطاب الملائكي”؟ ربما يحدث هذا في لحظات نادرة. لطالما مثل الشعر والموسيقى – كما في غناء الجوقة المتجانس – تجلياتٍ يقترب فيها البشر من محاكاة الملائكة. خذ مثلاً قصيدة “قوبلاي خان” لصموئيل تايلور كوليريدج، حيث يغيب المعنى الحرفي لتحل محله القوة الإيقاعية. فتجربة القصيدة لا تقوم على فهم دلالات الكلمات، بل على انسياب إيقاعاتها في الوجدان.
إن صوت القصيدة يستقر في أعماقنا قبل حتى أن نعي مغزاها.
لقد أثار هذا النوع من الكلام فضول بيكو، حيث كتب: “الأصوات التي لا تعني شيئاً، تمتلك قوة سحرية أكبر من تلك التي تعني شيئاً.”
المشكلة، مع ذلك، هي أن هذه اللغة عديمة المعنى ليست عملية جداً. فالكلمات تتيح لنا التواصل، وبينما قد تمنحنا الحياة لحظات نادرة (على حد تعبير الشاعر فيليب لاركن) ندرك فيها الوجود ككل، فإن معظم الوقت نحتاج إلى التمييز بين الأشياء لنتعايش مع العالم. وقد وقع بيكو نفسه ضحية لهذه المعضلة عندما استسلم لحماس متوهج وفوضوي قبل أيام من وفاته المبكرة في سن الحادية والثلاثين، حيث أخذ يخربش صفحة تلو الأخرى بما يصفه ويلسون لي بأنه “هذيان سامٍ”.
أصبحت كتابات بيكو “مشوشة للغاية، مشطوبة ومكتوب فوقها، مرقعة ومربكة، لدرجة أنه خلف وراءه غيماً كثيفاً وخليطاً يستحيل حله حيث يطارد غير المقروء وغير المفهوم المستحيل تصوره”. يبدو أن بيكو، في محاولته لتجاوز “التعدد”، لم يجد سوى الضجيج.
إذن هناك خط رفيع يفصل بين اللغة التي تتجاوز تعبيرها والهذيان، سواء كان سامياً أو غيره. لكن هل يمكننا التمييز بين الاثنين بشكل موثوق؟ لم يعش بيكو طويلاً بما يكفي لحل هذه المسألة، وويلسون لي لم يحلها تماماً في كتابه أيضاً.
إن “قواعد الملائكة” مثل حلم بيكو بالفلسفة الكونية، تعثر بطموحها الزائد؛ حيث تنسج خيوطاً كثيرة لدرجة يصعب معها متابعة السرد. إن إلمام ويلسون لي بمواضيعه، من حياة بيكو إلى علم وجود الملائكة إلى الفلسفة الأفلاطونية، مثير للإعجاب.
لكن حجة حاسمة حول تأثير بيكو لا تتجلى بوضوح. من الجليّ أن فلسفته واهتمامه باللغة كانا متكاملين، لكن يظل المرء يتوق إلى توضيح أكثر جلاءً للعلاقة بين هذين الحقلين من البحث.
نبقى غير متأكدين كيف يمكننا تقييم بيكو: هل كان صاحب رؤية أم فاشلاً؟ جزء من المشكلة في تقييم إرثه، كما نعلم، هو فهم الظروف الصعبة التي كان بيكو يعمل في ظلها. إن مشروعه “لتوليف فكر العالم المعروف” اصطدم بعقيدة الكنيسة وواجه معارضة قوية. يتميز بيكو بكونه أول فيلسوف يتم حظر كتابه رسمياً من قبل الكنيسة. إن عدم شهرة بيكو في أيامنا يعود جزئياً إلى قمع أفكاره وتقييد تأثيره على معاصريه. لكن يبدو أن كتاب ويلسون لي لن ينجح في تقديمه كنجم فكري في عصرنا الحالي: فبينما يغوص الكتاب في منهجيته الموسوعية الواسعة، يظل “قواعد الملائكة” غامضاً في تصويره لبيكو، تاركاً شخصيته لغزاً لم يحل بعد.
لعلّ الإنجاز الأهم الذي حققه بيكو – دون قصد – كان الكشف عن استحالة مشروعه الفلسفي. فكما في نظرية المجموعات الرياضية، حيث يستحيل وجود مجموعة شاملة تضم كل الأشياء بما فيها نفسها، فإن محاولة بيكو لصياغة فلسفة كونية شاملة كانت محكومة بالفشل، لأنها تظل دوماً منفصلة عن الأفكار التي تسعى لوصفها.
ويوضح ويلسون لي أن بيكو كان مدركاً لهذه المعضلة:
يبدو أن بيكو شعر أكثر من غيره بالإحباط الناجم عن فكرة أن الفكر، بغض النظر عن مدى حدته وقوته ورفعته، يظل محصوراً للأبد داخل دائرة تصوره الخاص، دون أن يحدث أدنى تغيير في القوانين الثابتة التي تحكم العالم الخارجي.
فعلى الرغم من مواهبه، التي شملت براعة مذهلة في اللغات وذاكرة حادة خارقة، لم يستطع بيكو تجاوز الفجوة بين الفكر والواقع.
حتى لو كان مشروع بيكو لاحتواء “كل الأشياء القابلة للمعرفة” في فلسفة واحدة مستحيلاً، فإن اهتمامه باختبار حدود اللغة يظل شديد الأهمية في زماننا. في الفصل الأخير من “قواعد الملائكة” (وهو أكثر الفصول إثارة في الكتاب)، يستكشف ويلسون لي الظروف المختلفة التي ذابت فيها الحدود بين الأفراد بفعل اللغة، مما أدى – إن لم يكن إلى كشف “الوحدة الكامنة” – إلى تجربة جماعية قوية على الأقل.
فالتحدث يعني ثني إرادة الشخص الآخر تجاه إرادتك؛ هذه قوة يمكن – كما يشير ويلسون لي – أن يُساء استخدامها بسهولة. فكر في خطابات هتلر، ذلك “المشهد حيث تندمج الحشود الهائلة في كيان واحد عبر قوة كلماته الإيقاعية”. إن “الترانيم المنومة” لهتلر – كما يخبرنا ويلسون لي – حولت “الناس إلى آلات” في ما يمكن اعتباره انعكاساً مشؤوماً لمفهوم “الكلام الملائكي”.
لذا، ومن المتوقع، تستمر النقاشات المحتدة حول حرية التعبير، وقيمتها ومخاطرها المحتملة. تماماً كما أدركت الكنيسة القدرة التخريبية لكتابات بيكو، يشير ويلسون لي إلى “الطاقة الاستثنائية التي تستثمرها ثقافتنا في تحصيننا ضد الكلام الآسر”. فالحضارة الغربية، كما يقول، تطاردها “رؤى كابوسية للامتثال الشيوعي وتلقين الطوائف”. و في المقابل، يدفعنا العصر الحديث بعيداً عن الفردية بشكل متصاعد، حيث يصور ويلسون الإنترنت باعتباره “كائناً فائقاً” تتفوق قوته الجاذبة في إذابة الفرد في بوتقة الجماعية، على قدرات أبرع الخطباء بلاغة وحضوراً.
يتوقف المؤلف عن التصريح المباشر بدور المعلومات المضللة عبر الإنترنت في تشكيل الأحداث السياسية العالمية الأخيرة، لكن قراءة متأنية لتحليل ويلسون لي تكشف مغزى عميقاً: فالقدرة الناقلة للغة، بشفريتها المزدوجة، قد تدفع بنا إلى هوة الفوضى بقدر ما تستطيع أن ترفعنا إلى قمم السمو والتناغم.
عن مجلة :
 منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية