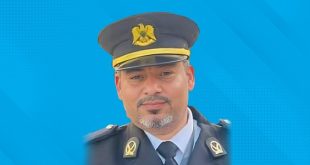تقارير اجتماعية
كوثر الفرجاني
ما تزال مأساة نازحي الوطن هي الشغل الشاغل الذي يؤرقنا؛ ويؤلمنا؛ ويجرح لحمتنا الوطنية في الصميم، منتظرين أن تتبنى السلطات المحلية، أو الحكومات الحالية معالجة هذه المأساة، وأن تنظر فيها، أو تلتفت إليها مجرد التفاتة، هذه المأساة التي بدأت تتوالد وتتناسل وتتكاثر، مخلفة المزيد من الأمراض والإعاقات الاجتماعية، وما يزيد من الأمر سوءا في ضوء عدم وجود حلول جذرية لهؤلاء الليبيين النازحين، هو ولادة جيل جديد يمكن أن نطلق عليه أطفال مخيمات النزوح، أطفال ولدوا في أصعب الظروف الإنسانية وأسوئها على الإطلاق، جيل لو كان لديه الخيار لاختار عدم الخروج إلى هذه الدنيا، رافضا الحياة بهذا الشكل، على رقعة جغرافية من المفترض أنها وطنهم.
فجأة، وبدون مقدمات، يجد الفرح سبيله إلى قلوب أطفال لا تعرف للفرح طريق، ليبدد ولو قليلا من ليل غربتهم المؤقتة التي طالت، بعد أن نزحوا من قراهم وبيوتهم ، تحت وابل من الرصاص المنفلت عقاله، والخارج عن كل القيم التي كرستها الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية، فعند قدوم كل وافد جديد أو وجه غير مألوف للمخيمات البائسة، التي تحولت إلى رمزية للقهر والشقاء الإنساني والغربة داخل الوطن، مع كل وجه جديد يدلف مراكز إيواء النازحين تشع العيون فرحا بقدومه، وكأن تلك القلوب الصغيرة تستشعر أن قلوبنا معهم، وأننا مع كل أهالي تاورغاء، وكل أهالينا ممن اجبروا على النزوح في ظروف قهرية قسرية تتنافى وأبسط المفاهيم المتعارف عليها إنسانيا وأخلاقيا، معهم قلبا وقالبا في المطالبة بعودتهم إلى بيوتهم وقراهم ومرابع صباهم.
وجع ومرارة
رغم كل الوجع والمرارة المزروعة في مخيمات النزوح، إلا أن الأطفال فيها يصرون على التشبت بالحياة، وصناعة الفرح في أبسط صوره، فما أن يحل العيد ضيفا، أو يبدأ العام الدراسي، تجدهم وقد استعدوا للذهاب لمدارسهم وملاعبهم، في صورة تضفي طعم الفرحة وبهجة الحياة في كل أزقة المخيم، ولا تكتمل الفرحة إلا بحصولهم على الأشياء الصغيرة الني تبهج الأطفال وتدخل السرور عليهم، وهو ما يحلم به كل طفل في هذا العالم، لعبة، أو حقيبة مدرسية، أو بدلة عيد، ولأنه طفل، وجد نفسه – قسرا- في عالمه البائس، داخل مخيمات النزوح، وكونه طفلاً صغيراً يحلم بأحلام صغيرة ، بقيت حتى أحلامه في هذا الوضع النزوحي البائس صغيرة بائسة تتوافق وعالم البؤس الذي يحيا ويترعرع فيه.
في هذا العدد من صحيفة ( الصباح ) وبكل أسف، ننقل لكم مشاهد ترسمها براءة الطفولة البائسة التعيسة، من داخل مخيمات النزوح ومراكز إيواء النازحين، ليس تلك التي تطوق العاصمة طرابلس فتخنقها، أو تلك التي نمت في بنغازي فشوهتها، فحسب، بل مراكز ومخيمات النزوح حتى في أجمل المدن بالمنطقة الوسطى بالجفرة، وغيرها.

أطفال الشتات
مراكز إيواء للنازحين، وكأنها سمة باتت تميز المدن في ليبيا، فلا تخلو أية مدينة في مختلف الأقاليم الليبية من مركز او اثنين وحتى أكثر، من وجع المخيمات وجراح الشتات، التي لا تتسع عدسة تصوير، ولا كلمات ترسم حيثيات الواقع، فالترحال والنزوح لا تكفيه صورة جماد، أو كلمات من مداد، فتجربة الطفل النازح تنقلت بين الوجع والترحال، لتخطف من واقع مخيمات النازحين في ليبيا – ولأول مرة- ومنذ الاحتلال الإيطالي صورا تفيض فقرا وعوزا، وألم مواطنين ينتظرون العودة التي لا تأتي.
عيون مطفأة، سحنات سمراء بريئة، وتقاسيم الوجه الطفولي، يوحدها بريق الأمل المرسوم فيها، حيث يتماهى الأطفال في مشهد حزين، تتماوج فيه عيونهم بالتساؤلات، وبريق يشي بوعد صادق، كأنهم أرادوا أن يقولوا طال انتظارنا في مخيمات النزوح، التي يصل عدد سكانها بالآلاف المؤلفة من النازحين، تجاوزت فيها نسبة الأطفال 40 % مع ازدياد مستمر في أعدادهم مع كل مولود جديد، تقول تلك العيون الصغيرة أنها لا تجد أكثر من (متر×متر) من المساحة في أحسن الأحوال، للعب خارج أسوار علب الصفيح التي يقطنون بها، فطبيعة البناء العشوائي داخل المخيمات لم تترك لهم حتى مساحات للمرور
قلوب وأحلام صغير
أطفال مخيمات النزوح، يفتقدون أبسط حق في أية بقعة من العالم، وهو اللعب، حيث أصبح طفل المخيم محصورا داخل الأزقة الضيقة، بعد الإضافات والتحويرات العشوائية التي لا تنتهي بمراكز إيواء النازحين، حتى تحولت إلى بيوت صفيح وعشوائيات تطوق العاصمة والمدن وتخنقها، فأصبح الطفل في ليبيا محروما من أبسط أحلامه التي لا تتخط حدود الملاعب، حيث أعلى سقف للحلم عنده، كرة بملعب صغير آمن، يرسم البسمة على وجوه الاطفال الذين ذاقوا طعم الظلم في أول خطوات حياتهم، ومع استمرار الحلم وتكراره، يدرك هذا الطفل أن ليس أمامه إلا الحلم، لأن هذا كل ما بحوزته، يحمله في قلبه بغصة، حتى مع تزايد حالات الموت البطيء، لأمهات محاصرات داخل المخيم، بالموت المعنوي حيث كرهن أعمارهن التي يبدو أنها ستمضي داخل مخيمات النزوح، فيما تتفرج عليهم الحكومات المتعاقبة ، ولا تبذل جهدا لعودتهم، بحجج وذرائع وهمية واهية، ومع استمرار الحياة والرضوخ للأمر الواقع نشأ جيل كامل من أطفال المخيمات، ولد فيها ولازال، والكل يدرك أنهم ليسوا ككل الأطفال، ورغم نداءاتهم المتكررة إلا أنها لم تلق أية استجابة أو صدى لدي أي من الحكومات التي توالت تباعا .

أثناء زياراتنا لمخيمات النزوح التي تطوق العاصمة طرابلس، وجدنا في كل زقاق وعتبة مجموعة من الأطفال يلعبون، دون أن يجدوا مكانا مناسبا للعب، مطالب بسيطة تدمع العين لدى سماعها من أطفال أضحت تلك أقصى أمنياتهم، ومع حلم زرعه آباؤهم فيهم بالعودة حيث المساحات الشاسعة والبراحات، حيث رسموا صورة لمدن لم يروها، وسمعوا عنها عبر الحكايات اليومية من الجد والجدة، عن موطن لم تطأه أقدامهم الصغيرة، ورسموا له صورة جميلة في خيالهم بعيدا عن البشاعة اليومية التي يعيشون فيها في مسقط رأسهم بمراكز الإيواء.
لاسكن ولا وطن
من يرى هذه الصورة لأطفال المخيمات في ليبيا، يدرك تماما أنها لا تبدو أمكنة محايدة وسط الصراعات والاشتباكات التي لا تنتهي بين أبناء الوطن الواحد، بل غدت جزء من الواقع اليومي ومن الحياة فيها، كما ستغدو جزءاً من حاضر و تاريخ الليبيين، صورة بائسة، بشعة، تشهد على انعدام الأمان ، وظلم أخوة التراب.
ورغم البؤس، تحمل تلك الصورة مضامين تعبر عن انتصار إرادة الحياة والسلام والفرح، رغم إدخال البلاد في أتون ظلمة أمنية ومعيشية، لتبقى مخيمات النزوح لا يرزح تحتها إلا هؤلاء المطحونين البؤساء، جراء ممارسات حكومية غير مفهومة، وانتهاكات وحشية لا حدود ولا مبرر لها، جعل حتى من أعياد الطفولة بلا قيمة، في ظل ما نراه من مشاهد تقتل الطفولة في مهدها، وتجعل من الطفل في ليبيا في وضع مأساوي، أشبه بما كنا نراه سابقا في الدول المنكوبة التي عانت من الصراعات والحروب الأهلية، لنرى اليوم في ليبيا أطفالا يولدون ويترعرعون ويكبرون في مخيمات، وكأنهم ليسوا مواطنين ليبيين، مطرودين ومشردين منحتهم الدولة الليبية حق اللجوء والإقامة، دون النظر إلى عواقب تشكل شريحة اجتماعية بدأت تطفو على السطح لم يعرفها المجتمع الليبي من قبل، ودون التدبر لما سوف ينتج عنه هذا الوضع الإنساني على المدى البعيد.
حكومات السبات
طفل ليبي ضاع حقه في دهاليز مكاتب المؤسسات والوزارات والهيئات ولجان الأزمة والمهجرين، فمن من هؤلاء خرج علينا وصرح في مؤتمر صحفي، أو في المناسبات القومية والأعياد، أو بلا مناسبة حتى، لمجرد (قطع الملام) وتكلم عن هذه الأعداد المهولة من الأطفال التي تقطن بمخيمات النزوح، وأنهم محرومون من التعليم، وإن حصل لا يتلقون تعليما جيدا، ويتسربون من المدارس، ومنهم أطفال من ذوي الإعاقة لا يعاملون معاملة تليق بالبشر، ويجبر الأطفال على مزاولة أعمال شاقة أكبر من أعمارهم بسبب العوز والفقر وانعدام السيولة المالية، أعمال لا تليق بطفولتهم وبراءتهم التي تخدش وتجرح حيث عمالة الأطفال في سوق الخضار وورش السيارات والشوارع حيث يبيعون محارم الورق والمناديل، ويتسولون من المارة ومن أصحاب السيارات الفارهة، وغيرها من التفاصيل المهمة التي شخصها ودرسها بعض الخبراء في المجال النفسي والاجتماعي، والتي تؤشر ضمنيا الى أن هؤلاء الأطفال عرضة لجميع أشكال العنف، وهو ما قد ينتج عنه ردود أفعال عدوانية أو عنيفة متطرفة، وقد ينعكس على سلوكهم بشكل لا يحمد عقباه، كونهم عرضة لكل أشكال الممارسات والسلوكيات غير السوية وقريبين من بؤر الجريمة

مخيم النزوح بسوكنة
لحظات توقفنا فيها في مخيم للنازحين بسوكنة، ببلدية الجفرة بالمنطقة الوسطى، بدأ ظهور الأطفال تباعا، من علب صفيح ومباني متهالكة لا تعرف رأسها من ساسها كما يقولون، ولا تعرف بدايتها من نهايتها، دهاليز ضيقة رمادية باردة أشبه بزنزانات السجون، مظلمة باردة مقفرة، في كل مرة وجدنا أطفالا تسبقهم ملامح الطفولة، يمدون أيديهم للسلام علينا وكأنهم يقولون، يدنا ممدودة إليكم مدوا لنا أياديكم، معبرين عن أنفسهم
تستغرب وأنت ترى الأطفال في مركز إيواء للنازحين التوارق بمحلة سوكنة ببلدية الجفرة ، سمات وعلامات الصحة والعافية في مكان بشع كهذا، وتتساءل هل هي نعمة ورحمة من اللهه، حالة من النشاط المفرط وهم يمشون معنا في دهاليز معتمة، وغرف موحشة مظلمة يسكن فيها هؤلاء الأطفال، فلا تجد إجابة!!!
حال أطفال نازحي الطوارق بسوكنة كحال كل أطفال النزوح واللجوء، لم تمنعهم أزقة المخيمات ولا رطوبة الجدران، ولا عفونة الصفيح والخشب، ولا حتى برودة القلوب القاسية من الحفاظ على البراءة والطفولة بقلوبهم كلما شعروا برغبة في التخلص من لعنة النزوح التي بدأوا يتوارثونها قسرا، يعيشون على ذكرى سمعوها أو بقيت بعضا من رتوشها في ذاكرتهم، قبل عذاب الترحال والنزوح.
بيوت وذكريات
تستغرب، وانت ترى طفلا في الخامسة وهو يرسم بيئات مشابهة لمناطق نزوحه، يرسم بيوتا صغيرة، بيتا جميلاً تظلله نخلة، ويملأ السماوات بالقلوب، ويكتب بألوان قوس قزح اسم منطقة النزوح، تستشعر حالة عشق وانتماء لمكان لم يره، أو بقيت جزءاً من ملامحه في مخيلته الصغيرة، مجرد ذكريات، تجعلك في حيرة وتتساءل: كيف يمكن لطفل أن يتورط بتفاصيل حياة لأطياف أناس عاشوا هناك يوما ما في مناطق النزوح، ويرسم تفاصيل وملامح مكان لم تطأه قدمه، ولكن من يسمع من طفل؟!
هاهم يرسمون بلداتهم وبيوتهم، وبيت الجد، و و(الجنانات) وبراحات اللعب، ويكتبون رسائل لا تصل لآباء رهن الاعتقال على جدران مخيماتهم، ليذكروهم بالعودة ويدعون لهم بالحرية والخروج من سجون الظلام، يكتبون على جدران المخيمات عبارات لعهد لم يقطعوه، وإنما يتوارثونه، حق العودة، وحق الحرية والعيش الكريم على أرض هم جزء منها، ولكنهم فيها بلا سكن .. وبلا وطن .هذا هو حال أطفالنا بمخيمات النزوح، داخل الوطن، فياترى ما هو حال أطفالنا المهجرين خارج حدود الوطن، حيث الشتات الأكبر، والغربة الحقيقية بكل صورها ومشهدياتها، والذين لا نعرف عنهم شيئا، سوى من نلتقطه من هنا وهناك، فهل هم أفضل حال، وهل وجدوا من ينصفهم خارج وطنهم؟ وهل عاشوا ويعيشون طفولتهم؟
ما يخفف الأمر قليلا.. أن الأطفال بالمخيمات هنا نستطيع أن نراهم وهم يمارسون فعل الحياة بكل إصرار، نتواصل معهم، ونواصل معهم حقهم في العودة، وفي المواطنة والحياة الكريمة، وحقهم في الرجوع.
طالت غربة اطفال مخيمات النزوح..طالت غربة أطفال تاورغاء، وكل الأطفال .. وكل ما نرجوه أن يكون الزمن الآتي زمنهم حتما.. وقوافلهم راجعة لا محالة .. وستحط رحالها حتما .. بأرض النخيل الحزين.
 منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية