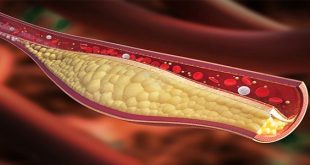الصباح/ حنان علي كابو
في أدبِ الرحلات، يعرفُ الروائي جيداً كيف ينفخُ الروح، في الأماكن التي تسوقه إليها المغامرة والتشويق، وكيف يطوعها خدمةً لمسار الحكاية..
يحفظ التفاصيل جيداً، كل شاردة وواردة، ويجيدُ الإمساكَ بلُبَّ الدهشة، حتى تغدو الآسرةَ بامتياز..
فمتى يَحيدُ الروائي عن الحقيقة أحياناً، ويجنحُ لخياله لصالح التشويق..؟
لايقفُ في خانة الحقيقة دون أن يبرحها ….!
تستهلُ بادئ ذي بدء، لكاتبة والصحافية من مصر “حنان سليمان”، بوجهة نظرها، قائلة:- “الروائي ليست مهمته أن يقول الحقيقة، فهو ليس صحفياً، ولا مؤرخاً، ولا صانع وثائقيات..

الروائي يطرح فكرةً تؤرقه، شهدها أو سمع عنها، وهذا ما فعلته في روايتي “الراعي”، التي تدور حول فكرة عبادة الفرد، أو يطرح تساؤلاً ما يشغله، ويتعامل مع فرضيات “ماذا لو”، التي تضع سيناريوهات متخيلة، فيتتبعها، وربما يغيّر بها مصائر ومسارات التاريخ، بتغيير أحداثه الكبرى، في هذين النمطين”..
وتضيفُ:- “يذهب الروائي بخياله لبناء عالمه، ورسم شخوصه، مستلهماً من حصيلة معارفه وبيئته، وفيها جزء منه، وممّن يعرف..
وحتى في حال كان المنطلق رصد المجتمع بقضاياه العصرية، وعلاقاته المتشابكة، فيما يشبه الكتابة البانورامية، التي تظهر فيها الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فالروائي هنا ينتقي ما يريد من الواقع، ويضيف إليه..
في جميع الأحوال هو لا يقف في خانة الحقيقة، دون أن يبرحها..
يتبقّى بعد ذلك طريقة الحكي، وعليها الرهان الأكبر لاستمرار التشويق، وجذب القارئ في العموم. “..
الروائي أكثر حرية في التوثيق وإضافة الخيال …!
وتشيرُ الكاتبة الروائية “رزان نعيم المغربي”، في ذاتِ السياق، إلى أن الروائي عندما يكتب نصّه السردي، ويحدث ذلك في الرواية والقصة سواء، لا يفكر أبداً أنه بصدد توثيق المكان الذي جرت فيه الأحداث..

وتضيفُ قائلة ” لأن أصلَ الحدث في العمل، من أجل دفع السرد إلى الأمام، بعض الأعمال تخلو من أي غشاوة، إلى مدينة بمعالم واضحة وحتى اسم، سواء لها أو لشوارعها أو ما تشتهر به، تكون محض خيال روائي.. بمعنى آخر، يصبح تركيز الفكرة حول أبعادٍ جديدة، لا يريد الكاتب أن ترتبط بالمكان، ويمكن أن تتطابق مع بقعٍ كثيرة في هذا العالم..
ونتذكر معاً، بما صُنّف بالرواية الواقعية، وهي تقع ضمن الأدب الكلاسيكي اليوم، أنها ساهمت في تقديم جغرافيا، ربما تكون دقيقة للأماكن التي جرت فيها أحداث العمل، على سبيل المثال روايات “نجيب محفوظ”. بل حتى العناوين كانت تُشتقُّ من أسماء العواصم والمدن..
مازلتُ أتذكر حينما قرأت “نجيب محفوظ” وأنا صغيرة، وقبل زيارة القاهرة، كيف تشكّلت في خيالي صورةً للمدينة، بأسواقها ومبانيها، وحاراتها الشعبية ومقاهيها، وبذاتِ الأسماء..
هذا النوع من النصوص، يقتربُ الكاتب من القارئ بقوة، ويلامس فيه مشاعر دافئة، وكأنه يوثّق لمرحلةٍ تاريخية معينة.”..
وتقفُ “المغربي” في مقاربتها، من جادة الرسام الإنجليزي، قائلة:-
“سأتحدثُ من واقع تجربة خاصة، وعن روايتي الجديدة “الرسام الإنكليزي”، والتي احتوت على ذكر مدنٍ وقرى وعواصم متباعدة، تبدأ من قرية البردي ومدينة طبرق وبنغازي، إلى روما وفلورنسا ولندن..
في الواقع، أعتبرُ نفسي مهتمة بإبراز هوية الأماكن، ليس بالضرورة أن أصفها كما هي حرفياً، بل تشوبها انطباعاتٌ ومشاعر تلتصق بتلك الأماكن، التي كتبت عنها، وسرّي الصغير، أني لم أتمكن من زيارة البردي سابقاً، لكن اعتمدتُ على وثائق وصور وفيديوهات كثيرة، لاقترب من هذه البقعة، ولتصبح بيني وبينها علاقة دافئة جميلة، تمكنني من وصفها ومقاربتها بما يخدم النص الروائي، كما كان لدي وصفٌ لمقهى في لندن، وشقة.. هنا استعدتُ بذاكرتي إحدى الزيارات إلى لندن، وكيف كنتُ ضيفةً لدى صديقة تقيم في شقة فخمة، في أهم شوارع العاصمة اللندنية.. استعدتُ تلك الانطباعات، واستلفتُ منها ما يفيد في وصف المكان. أما المقهى في قرية قريبة من العاصمة، وفي زمن قديم، كان عليّ الاستعانة بمصادر تاريخية، واليوم يتوفر “غوغل”، لذي يمنحنا صوراً حيّة لأي مكان قديم أو حديث، ويمكن التجوال الافتراضي فيه، ووصفه بشكلٍ جيد.. لقد استخدمتُ كل التقنيات الحديثة، لأذهب في رحلةٍ إلى الماضي.”..
إذن.. تختلفُ زاوية النظر إلى الأماكن بين عملٍ وآخر، حسب ما يخدم النص، وقد يجد الروائي بأنه لا حاجة له بالوصف..
وشخصياً، لا أنتمي لهذه الرؤية.. بالذات عندما نعود بالزمن الى مائة عام، من الضروري هنا استخدام الخيال، ولكن ليس بشكلٍ عبثي، إنما بناءً على قراءةٍ تاريخية حول المعمار، والازياء والثقافة، في ذلك الزمن..
ما أودُّ قولَه: إن الكتابة في أدب الرحلات عملٌ جذّابٌ ومثير، لكنه يوثّق بشكلٍ دقيق لكل شيء، سواء المكان أو ثقافة المجتمع، الأزياء، المهرجانات، الفنون، والأسواق، كل ما يتعلق برحلته تلك..
أما الروائي، فهو أكثر حرية في التوثيق، وإضافة الخيال..
بناء صياغات خيالية تقربُ إحساس القارئ..
وترى الكاتبة والمترجمة “هايدي عبد اللطيف” أن كاتب أدب الرحلة، يحتاج اليوم الخيالَ أكثر من أي وقت مضى، لأسباب عديدة مفهومة..

وتضيف : بينها توفر شبكة الإنترنت التي صغّرت الإحساس بكبر العالم، بسبب قدرتها على الوصول بالمستخدم لأي مكان في العالم، عبر التطبيقات الحديثة، مثل “جوجل إيرث”، وغيرها.. وبالتالي، فاللمسة الجوهرية لكاتب أدب الرحلة اليوم، ليس تقديم ما يراه للقارئ بل نقل المشاعر والأحاسيس، وأيضا بناء صياغات خيالية، تقرب إحساس القارئ، بما سيتناوله الكاتب..
وهناك تجارب أدب رحلة، تستخدم اليوم حتى الشعر، أو افتراض لقاءات بين الكاتب وبين شخصيات افتراضية، لكي يبني بها إحساساً أدبياً، وأيضا تلعب دوراً في بناء حالةٍ من التشويق للقارئ.”..
وتوضّح في نفس السياق: “فأدب الرحلات المعاصر ينخرط في تفكيك رموزه الخاصة، من أجل استيعاب مساحة من الحرية، حيث يمكنه مرة أخرى تصوير رؤية موضوعية/ذاتية..
وقد أصبح من الواضح الآن، أنه لا يقوم بشكل أصيل بنقل واقع العالم؛ ومع ذلك، فإنه يمتاز بالقدرة على خلق عالم جديد، من خلال كتابة جمالية، أو تتبنّى القيم الأدبية..
وفي عصر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وصُحبة الكاميرا، والرغبة في توثيق اللحظة، تلك الرغبة التي امتلكها الغالبية، بحيث تجد مقاطع فيديو لأي مكان تتخيله أو لا تتخيله، يصعب إعمال الخيال المطلق.”..
وهنا تكمن الصعوبة، والتي يحاول الكاتب، أو هذا على الأقل ما فعلته في تدوين رحلاتي، استخدام عنصري التشويق واللغة الجمالية الأدبية بعناصرها، من دون الإخلال بمسار الرحلة، أو بواقعية الأماكن والشخصيات، بحيث إذا بحث عنها القارئ في محرك البحث “جوجل”، أو جاءته فرصة زيارة تلك الأماكن، مصطحبًا كتابي معه، يجدُ ما وصفتُه حقيقيًا..
 منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية